كيث جينكنز
ترجمة وإعداد – خلود سعيد عامر، عمرو خيري، سمية الرفاعي، حسين الحاج (ضمن أعمال معمل الترجمة والكتابة/سكة المعارف).
النص أدناه هو مُجتزأ من كتاب كيث جينكنز “إعادة النظر في التاريخ – Rethinking History“*. هي ترجمة بها قدر من التصرّف، حيث تجاوز المترجمون ترجمة بعض الفقرات ولخصوا بعضها.
في هذا الفصل، سأشرع في محاولة الإجابة عن سؤال “ما هو التاريخ؟”؛ حيث سأنظر في ماهية التاريخ للوصول إلى تعريف – واعٍ منهجيًّا ومتشكك – أتمنى أن يكون شامل بمكان ليُقدِّم نبذة ليس فقط عن “مسألة التاريخ”، ولكن أيضًا عن بعض المناقشات والمواقف المتعلقة بها.
عن النظرية
على مستوى النظرية سأتناول نقطتين: أولهما (سأجملها في هذه الفقرة ثم سأتفيض فيما بعد) أن التاريخ هو سلسلة من الخطابات حول العالم، لا تخلق العالم بمفهومه المادي الذي نعيش فيه ولكنها تعطيه كل المعنى الذي يستنبطه. يعد الماضي الجزء الظاهري من العالم الذي يهتم به التاريخ. إذًا، فالتاريخ كخطاب يقع في تصنيف مختلف عن الذي يهتم به في خطابه؛ بمعنى أن التاريخ والماضي هما شيئان مختلفان ويتحركان بحرية كلٍ بمعزل عن الآخر. يُمكِّن قراءة نفس المبحث بطريقة مختلفة باختلاف الممارسات الخطابية؛ حيث يُمكِّن قراءة المشهد ذاته وتفسيره بطرق عدة من قبل جغرافيين وعلماء اجتماع ومؤرخين وفنانين وعلماء اقتصاد إلخ، بينما توجد تفسيرات متعددة عبر الزمان والمكان، وهم ما يظهره التأريخ.
عادةً ما يصعب التفريق بين التاريخ والماضي، وربما يرجع أحد الأسباب إلى أننا كمتحدثين للإنجليزية دأبنا على الخلط بين التاريخ – وهو ما كُتب وسُجل عن الماضي- والماضي نفسه، وذلك لأن لفظ “التاريخ” يجمع الاثنين. ولهذا ربما يكون من الأفضل استخدام مصطلح “الماضي” للدلالة على الأشياء السابقة ومجال اهتمام المؤرخين، ومصطلح “التأريخ” للدلالة على التاريخ ومنهجية المؤرخين، بينما نحصر استخدام مصطلح “التاريخ” (معرفًا بالألف واللام) للدلالة على هذه العلاقات مُجمعة.
ولكن لماذا علينا التفريق بين الماضي والتاريخ؟
- الماضي قد حدث ووقع بالفعل، ويمكن فقط استرجاعه عن طريق المؤرخين بوسيط مختلف كليًّا مثل الكتب والمقال والأفلام التسجيلية إلخ، وليس كأحداث حقيقية. الماضي قد ذهب، وأما التاريخ فهو ما يصنعه المؤرخون منه عندما يشرعون في أداء عملهم. فالتاريخ هو عمل المؤرخين المتجسد في الكتب والدوريات إلخ التي نقرئها عندما ندرس التاريخ ونتخصص فيه، وهو ما يعني أن التاريخ – حرفيًّا – في المكتبات والجامعات ومثل هذه الأماكن. إذًا، عندما تبدأ في دراسة إسبانيا في القرن السابع عشر على سبيل المثال فإنك لا تذهب إلى إسبانيا ولا إلى القرن السابع عشر وإنما إلى المكتبة وأرشيف إسبانيا وما إلى ذلك؛ حيث تقع إسبانيا القرن السابع عشر – بين تصنيف ديوي. يتميز التاريخ (التأريخ) بالتناص والبناء اللغوي.
- فلنقل مثلاً أنك تدرس جزءًا من ماضي إنجلترا في القرن السادس عشر في أحد المقررات الدراسية، وأنك اعتمدت على كتاب جيوفري إلتونEngland Under the Tudors كمرجع للواجبات المدرسية، بالإضافة إلى الملاحظات التي دونتها خلال المناقشات داخل الفصل. وفي اختبار نهاية الفصل الدراسي نجحت وحصلت على إجازة في التاريخ الإنجليزي، لكنها في الحقيقة شهادة في أحد جوانب الماضي وفي كتاب إلتون.
- يبدو هذين المثالين المختصرين على التمييز بين الماضي والتاريخ حميدين وغير ضارين، لكن لهما تأثير ضخم. فمثلاً القليل فقط من النساء هن من يظهرن في التاريخ، أي كتب التاريخ؛ فقد تم إخفاء النساء من التاريخ واستبعادهن من معظم سرديات المؤرخين. وبالتبعية، ينخرط الاتجاه النسوي في مهمة كتابة النساء في التاريخ ودراسة البنية متعددة العلاقات للذكورية. يمكننا التفكير في كل المجموعات والشعوب والفئات والطبقات التي تم (ولا يزال) تهميشها من التاريخ، ولماذا، وما هي التبعات المحتملة إذا كانوا محوريين في مختلف السرديات التاريخية وكانت المجموعات المركزية الحالية هي المهمشة.
فلنتخيل مثلاً أننا نرى منظرًا طبيعيًا من خلال نافذة (ولكننا لا نرى المنظر كله لأن النافذة “تؤطره” حرفيًّا). لا يوجد أي شيء في المشهد مصنف جغرافيًّا، لكن قطعًا يُمكن لجغرافي تفسيره جغرافيًّا من خلال بعض أنماط الحقول أو ممارسات الزراعة، ويُمكن أن تصبح الطرق جزء من شبكات اتصال محلية أو إقليمية، ويُمكن قراءة الحقول والقرى من خلال التوزيع السكاني؛ ويُمكن لجغرافيا المناخ تفسير المناخ واقتراح طرق مناسبة للري. يصبح المشهد إذا جغرافيا. وبالمثل، يمكن لعالم اجتماع بناء نفس المشهد اجتماعيًّا: فيصبح سكان القرية بيانات للبنى الوظيفية وحجم وحدات الأسرة إلخ، ويمكن دراسة التوزيع السكاني من خلال الطبقة والدخل والفئة العمرية والنوع الاجتماعي، ويمكن قراءة المناخ من خلال تأثيره على الأنشطة الترفيهية إلخ.
يُمكن للمؤرخين بالمثل تطويع المشهد ليناسب خطابهم؛ فيمكن مقارنة أنماط الحقول اليوم بمثيلتها في السابق، وعدد السكان لعددهم خلال القرن التاسع عشر، ودراسة ملكية الأرض والقوى السياسية عبر الزمن، ولماذا توقفت وسائل انتقال بعينها عن العمل إلخ.
لا يخترع المؤرخون أو نظرائهم المشهد، لكنهم يخترعون كل تصنيفاته الوصفية وكل المعاني التي يمكن أن يتضمنها. ويأسسون الأدوات المنهجية والتحليلية التي تُمكنهم من دراسة المشهد وبناء خطاب عنه. من هذا المنطلق نحن نقرأ العالم كنص، فهي قراءات لا نهائية بالتعريف؛ بمعنى إننا لا نخترع حكايات عن العالم أو الماضي الذي نعرفه، ولكن أنهما يصلان إلينا كحكايات (سرديات) تُشكِّل الواقع، ثم تفكك هذه الخطابات ويعاد تشكيلها وتموضعها.
نظرًا إلى التمييز بين الماضي والتاريخ، تصبح المشكلة التي يواجهها المؤرخ الذي يريد تقديم الماضي ضمن التاريخ الذي يكتبه كالتالي: كيف يمكن الجمع بين هذين الشيئين معًا؟ الواضح أن هذه الصلة مغرية، فكيفية محاولة المؤرخ لمعرفة الماضي مهمة كل الأهمية لتحديد إمكانات ما هو التاريخ، وما الذي يمكن أن يكونه، ومن الأسباب أن مقولة التاريخ المعرفية (لا الإيمان أو محض التأكيد على أن هذه هي الحقيقة) هو ما يُطبّع الخطاب بطباعه (أعني أن المؤرخين لا يرون أنفسهم عادة بصفتهم كُتاب للأدب، رغم أنهم ربما كانوا كذلك دون قصد منهم). لكن بسبب الاختلاف بين الماضي والتاريخ، ولأن موضوع تقصي وبحث المؤرخين – في أغلب تجسداته – هو غائب من حيث أنه لا يبقى من الماضي إلا آثار قليلة، إذن فهناك وبوضوح أشكال عديدة من القيود التي تسيطر على الادعاءات/المقولات المعرفية التي يدلي بها المؤرخون. وبالنسبة لي، ففي هذا الربط بين الماضي والتاريخ ثلاث إشكاليات نظرية كبرى: إشكالية الإبستمولوجيا (كيف نعرف الحقيقة)، وإشكالية المنهج وإشكالية الأيديولوجيا، ولابد أن نناقش كل منها إذا أردنا حقًا معرفة ما هو التاريخ.
الإبستمولوجيا (من الكلمة الإغريقية episteme = المعرفة) تشير إلى مجال نظريات المعرفة الفلسفي. هذا المجال يُعنى بكيف نعرف أي شيء. ومن هذا المنطلق فالتاريخ جزء من خطاب آخر، هو الفلسفة، وهو خطاب يدور في فلك السؤال العام حول ما الذي يمكن معرفته بالرجوع إلى موضوع المعرفة المعني، وهو الماضي في هذه الحالة. وهنا قد يرى المرء المشكلة واضحة؛ لأنه إذا كان من الصعب تحصيل المعرفة عن شيء موجود، فإن قولنا شيء عن موضوع غائب مثل الماضي وتاريخه يُعد بالغ الصعوبة. يبدو واضحًا أن كل معرفة عن الماضي والتاريخ إذن هي معرفة أولية غير واثقة الخطى، يشيدها المؤرخون الذين يستعينون عليها بأنواع بلا حصر من الافتراضات الأولية وفي ظل ضغوط كانت لا تسري قطعًا على الناس في الماضي. لكن ما زلنا نرى المؤرخين يحاولون أن يقدموا لنا شبح الماضي الحقيقي، الماضي الموضوعي الذي يسوقون حوله سرديات يفترض أنها دقيقة بل وحقيقية. على أنني أعتقد أن هذه الادعاءات اليقينية لا يمكن تحقيقها، ولم تكن كذلك يومًا، وبكل وضوح. لكن أن نقبل بهذا، أن نسمح للشك أن يجري مجراه، فهذا يؤثر بالطبع على تصورنا عن التاريخ وماهيته، أي أنه يقدم لنا جزء من إجابة سؤال ما هو التاريخ وما يمكن أن يكونه. إذ أن المرء إذا أقر بأنه لا يعرف حقًا، وأن يرى التاريخ (منطقيًا) بصفته أي شيء تريده أن يكون، فهذا يفرض علينا سؤال عن كيف تمت كتابة سرديات تاريخية معينة بشكل لا بشكل آخر، وليس فقط من منطلق إبستمولوجي، إنما من المرتكزين المنهجي والأيديولوجي أيضًا. هنا، فما يمكن معرفته وكيف نعرفه هي مسألة تتحقق عن طريق تفاعلنا مع السلطة/القوة. لكن بمعنى من المعاني فالسبب يعود فقط إلى أن التاريخ هشّ معرفيًا (أبستمولوجيًا). لأنه إذا كان بالإمكان أن نعرف بشكل قاطع ما حدث في واقعة تاريخية، بحيث لا نعود لبحثها مرة أخرى، فلن تبقى هناك حاجة إلى كتابة المزيد من التاريخ، فما فائدة السرديات التاريخية الكثيرة والمتكررة حول نفس الحقيقة التي تم اكتشافها بالفعل؟ سوف يتوقف التاريخ (بمعنى السرديات التاريخية لا حركة “الماضي/المستقبل”)، وإذا فكرت أن فكرة إيقاف التاريخ (المؤرخين) عجيبة، فأرجو أن تراجع نفسك: فإيقاف التاريخ لم يكن فقط جزء من رواية 1984 لأورويل على سبيل المثال، إنما هو أيضًا جزء من التجربة الأوروبية في الثلاثينيات من القرن العشرين، وهي الحقبة والمكان اللذان جعلا أورويل يفكر في هذه الفكرة.
الهشاشة الإبستمولوجية/المعرفية إذن تسمح بتعدد قراءات السرديات التاريخية التي يدونها المؤرخون (ماضٍ واحد وسرديات عديدة حوله)، فما الذي يجعل التاريخ هشّ إبستمولوجيًا؟ هناك أربعة أسباب أساسية.
أولًا (وفيما يلي فأنا أبني على مقولات ديفيد لوفينثال في كتابه “الماضي بلد أجنبي”) لا يمكن لمؤرخ أن يغطي ويعيد تغطية أحداث الماضي في كليتها لأن محتوى الماضي هذا لا يمكن حصره. لا يمكن للمرء إلا أن يسرد جزء ضئيل للغاية مما حدث، ولا توجد رواية تاريخية لمؤرخ تحاكي التاريخ كاملًا. فأغلب المعلومات الخاصة بالماضي لم تدوّن قط، وأغلب ما تم تدوينه منها سهل التبخر.
ثانيًا، لا يمكن لرواية تاريخية ما أن تبعث الماضي كما كان، لأن الماضي ليس سردية/رواية إنما هو أحداث ومواقف وهلم جرأ. ولأن الماضي قد ذهب، فلا يمكن لسردية ما أن تحاكيه، إنما هي تُقارن إلى غيرها من السرديات عن هذا الماضي. إننا نحكم على “دقة” عمل المؤرخين عن طريق مقارنة عملهم بتفسيرات مؤرخين آخرين للماضي، ولا توجد في الواقع رواية تاريخية واحدة حقيقية، ولا تاريخ يسمح لنا بأن نقارن جميع الروايات التاريخية إليه: فلا يوجد “نص” صحيح تعد التفسيرات الأخرى محض تنويعات عليه، فلا يوجد إلا التنويعات. هنا تعد مقولة الناقد الثقافي ستيفن جيلز دقيقة، إذ قال إن ما حدث في الماضي يُفهم دائمًا عن طريق فحص الطبقات المتراكمة من التفسيرات الماضية وعن طريق قراءة العادات والتصنيفات التي ساقتها الخطابات التفسيرية الماضية/الحاضرة. هذا التصور يسمح لنا بالوصول إلى نقطة مفادها أن هذه الطريقة في رؤية الأمور تجعل دراسة التاريخ (الماضي) هي بالضرورة دراسة لأعمال المؤرخين، مع اعتبار سرديات المؤرخين لا كدراسة للتاريخ إنما كجزء من هذا التاريخ. أنتقل الآن إلى النقطة الثالثة.
النقطة الثالثة مفادها أنه بغض النظر عن مدى قدرتنا على تحري الدقة في التحقق من الماضي، يبقى التاريخ بالضرورة بناء شيده شخص، هو تجسيد لوجهة نظر المؤرخ بصفته “السارد”. وعلى العكس من الذاكرة المباشرة فالتاريخ يعتمد على عيون وصوت الغير. فنحن نرى الماضي هنا من خلال مُفسّر يقف بيننا وبين أحداث الماضي. بالطبع وكما قال لوفينثال فالتاريخ المكتوب “من حيث الممارسة” يقلل من حرية المؤرخ المنطقية في كتابة أي شيء إذ هو يتيح للقارئ الاطلاع على مصادر المؤرخ، لكن وجهة نظر المؤرخ وتحيزاته تبقى هي التي تشكل اختيار المواد التاريخية وطريقتنا في تقديم الماضي هي التي تحدد ما سنفهمه عنه.
الماضي الذي “نعرفه” متماس ومرتبط دائمًا بآرائنا حوله وبحاضرنا. تمامًا كما نحن نتاج للماضي فالماضي المعروف (التاريخ) هو من آثارنا نحن. لكن لا يمكن لشخص منغمس في الماضي أن يفصل نفسه عن معرفته وافتراضاته الخاصة. قال لوفينثال إن لتوضيح الماضي “يتجاوز المؤرخون السجل القائم إلى وضع افتراضات تتبع طرق تفكير الحاضر”. نحن حداثيون وكلماتنا وأفكارنا لا يمكن إلا أن تكون حداثية، على حد قول ميتلاند: “تأخر الوقت على أن نكون إنجليز قدامى”. هناك إذن قيود تحدد سلطة التفسير وتخيل الكلمات. يقول الشاعر كليبنيكوف في “مراسيم للكواكب”: “انظروا، الشمس تطيع كلماتي، ويقول المؤرخ: انظروا، الماضي يطيع تفسيري”.
هناك مثال معروف عن كيف أن المصادر تحول دون حرية المؤرخ الكاملة وفي الوقت نفسه تثبت الأمور بدرجة قادرة على الحيلولة دون الخروج بتفسيرات لانهائية للماضي. هناك اختلافات كثيرة حول نوايا هتلر بعد اكتساب السلطة، وأسباب الحرب العالمية الثانية. وهناك خلاف على هذه النقطة بين “أيه جيه بي تيلور” و”إتش تريفور-روبر”. هذا الاختلاف لم يكن مستندًا إلى قدرات الاثنين كمؤرخين، فقد كان لدى كل منهما خبرة واسعة، وكانت “مهارات” المؤرخ لديهما كبيرة، وقد قرأ الاثنان الوثائق وفي هذه الحالة كانت الوثائق التي قرأها كل منهما واحدة، لكنهما اختلفا. إذن فبينما قد تحول المصادر دون قول بعض الافتراضات، ففي الوقت نفسه فإن نفس المصادر والأحداث المتماثلة لا تعني وجود قراءة واحدة.
الأسباب الثلاث السابقة للهشاشة الإبستمولوجية تستند إلى فكرة أن التاريخ أقل من الماضي، وأن المؤرخين لا يمكنهم استعادة شيء من الماضي سوى شذرات قليلة. لكن النقطة الرابعة هي أننا وبشكل ما نعرف عن الماضي أكثر مما عرفه الناس الذين كانوا يعيشون في الماضي. فمع ترجمة الماضي إلى اصطلاحات حداثية، واستخدام معرفة ربما لم تكن متوفرة في الماضي، يكتشف المؤرخ ما كان منسيًا عن الماضي ربما، ويجمع بين خيوط لم يسبق لأحد أن جمعها مثله. فالناس والتكوينات الاجتماعية يدخلون في علاقات وعمليات لا يمكن رؤيتها في تمامها إلا بعد انتهائها، والوثائق والآثار الباقية الأخرى تُنزع من سياقاتها الأصلية لغرض توضيح – مثلًا – نسق ربما لم يعن الكثير أو يعني أي شيء لمؤلفي هذه الوثائق والآثار التاريخية. وكل هذا – كما يقول لوفينثال – حتمي. فالتاريخ دائم التغير وهو يبالغ في تقدير أحجام الأمور التي حدثت في الماضي: “الزمن يُختذل، ويتم اختيار تفاصيل بعينها ويُسلط الضوء عليها، ويتم تكثيف الأعمال وتُبسط العلاقات، ليس لتبديل الأحداث التي وقعت، لكن لجعلها ذات معنى”. حتى المؤرخ الأكثر تحر للجوانب العملية عليه اختراع بنية سردية لإعطاء شكل للزمن وللمكان. ويقول لوفينثال في ختام، إن التاريخ المكتوب كما نعرفه يبدو لنا أكثر قابلية للفهم من تصورنا عن مدى قابلية الماضي للفهم.
هذه إذن هي الحدود الإبستمولوجية الأساسية والمعروفة. لقد كتبتها سريعًا وبشكل انطباعي ويمكن قراءة المزيد عند لوفينثال وآخرين. وأنتقل الآن إلى المسألة التالية. فإذا كانت القيود الإبستمولوجية هي ما يمكن معرفته، إذن فهي متصلة بوضوح بكيفية محاولة المؤرخين معرفة أكبر قدر يمكنهم معرفته. وفي حالة المنهجيات التي يستخدمها المؤرخون، كما هو الحال بالنسبة إلى الإبستمولوجيا، فلا توجد طرق محددة يجب استخدامها لأنها صحيحة، فمنهجيات المؤرخين متشظية ومختلفة بقدر الإبستمولوجيا.
حتى الآن حاججت بأن التاريخ خطاب متغير ومتحول يبنيه المؤرخون وأنه لا يمكن تحديد قراءة واحدة صحيحة للماضي. لكن رغم معرفة المؤرخين بكل هذا، فأغلبهم يتجاهل على ما يبدو هذه النقطة، ويسعى لتقديم الماضي بحياد وموضوعية. وهذا السعي وراء الحقيقة تتداخل فيه أيضًا المواقف المنهجية والأيديولوجية للمؤرخين.
من ثم وعلى اليمين الإمبريقي (إلى حد ما) قال جي. إلتون في “ممارسة التاريخ” في بداية فصله المخصص لإجراء البحث التاريخي: “دراسة التاريخ إذن هي بمثابة البحث عن الحقيقة” ورغم أن الفصل نفسه ينتهي بسلسلة من المؤهلات المطلوبة لإجراء البحث التاريخي، فقد أضاف: “رغم أنه [المؤرخ] يعرف أن ما يدرسه حقيقي لكنه يعرف أنه لن يتمكن من تقديم كل هذه الحقيقة كاملة… فهو يعرف أن عملية البحث التاريخي وإعادة البناء لن تنتهي أبدًا، لكن أيضًا واعٍ بأن هذا لا يجعل عمله غير حقيقي أو غير مشروع”.. من الواضح إذن أن مثل هذه الثغرات لا تؤثر على مقولة إلتون بأن التأريخ هو “البحث عن الحقيقة”.
وعلى جانب اليسار الماركسي (إلى حد ما) قال إي بي تومسون في “فقر النظرية” أن “لفترة… راح مفهوم التاريخ المادي ينمو في ثقة. وكممارسة ناضجة… فلعله أقوى مجال علمي مشتق من التقاليد الماركسية. فعلى مدار حياتي… كان التقدم كبيرًا، وللمرء أن يفترض أن هذا التقدم هو تقدم في المعرفة”. يعترف تومسون بأن كلامه هذا لا يعني أن هذه المعرفة خاضعة “للإثبات العلمي”، لكنه يراها معرفة حقيقية على كل حال.
وفي الوسط الإمبريقي (إلى حد ما)، يثمّن أيه. مارفيك في “طبيعة التاريخ” ما يسميه “البُعد الذاتي” لسرديات المؤرخين، لكن بالنسبة إليه فهذا البُعد لا يكمن في الموقف الأيديولوجي للمؤرخ، إنما في طبيعة الأدلة والقرائن، وكون المؤرخين “مجبرين على استعراض تفسيراتهم الشخصية لعدم كمال مصادرهم التاريخية”. من ثم فإن مارفيك يحاجج بأن وظيفة المؤرخ هي إعداد “قواعد منهجية صارمة” يقلل بموجبها تدخلاته “الأخلاقية”. إن إلتون حريص على إثبات أنه ليس لمجرد أن التفسير التاريخي لا يعتمد على قوانين ثابتة فلا يمكن أن تسري عليه قواعد صارمة. وبناء عليه، فالنسبة إلى المؤرخين فالحقيقة والمعرفة والمشروعية متقة من قواعد وإجراءات منهجية صارمة. وهذا هو ما يقلل من الخروج كثيرًا عن الحقيقة في التفسير.
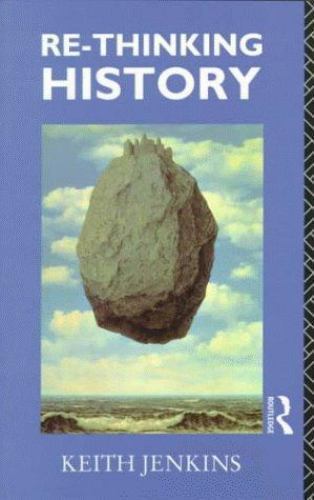
مقولتي مختلفة، فبالنسبة إلىً فما يحدد التأويل أو التفسير يتجاوز المنهج والتدليل ويكمن في الأيديولوجيا. إذ بينما يتفق معظم المؤرخين على أن المنهجية الصارمة مهمة، فهناك مشكلة: أي منهجية صارمة تحديدًا هي المطلوبة. ففي قسمه الخاص عن المناهج المتبعة يعرض مارفيك في كتابه مجموعة منهجيات يستطيع المرء (افتراضيا) أن يختار مما بينها. إذن هل تود أن تتبع هيجل أم ماركس أم ديلثى أم فيبر أم بوبر أم همبل أم آرون أم كولينجوود أم دراى أم أوكيشوت أم دانتو أم جالى أم والش أم أتكينسون أم ليف أم هيكستر؟ هل تريد الاتفاق مع الإمبريقيين الحداثيين، أم النسويين، أم المدرسة الحولية (annales school)، أم أتباع الماركسية الجديدة، أم المصممين الجدد، أم المتخصصين في الاقتصاد القياسي، أم البنيويين، أم ما بعد البنيوية – أو حتى مع مارفيك نفسه – على سبيل طرح بعض الأمثلة على المنهجيات؟.. وهذه قائمة قصيرة!
النقطة هي أنه حتى لكى تقوم بالاختيار، فما هي المعايير؟ كيف يستطيع المرء معرفة أن هذه هي المنهجية التي تقود إلى الماضي الأصح؟ يمكن بالتأكيد أن يكون كل منهج من المذكور دقيقًا وصارًما، وكل منهج متماسك داخليًا ومتسق مع نفسه، لكنه في الوقت نفسه نظام مغلق على ذاته. ذلك أنه، قد يستطيع أن يدبر لك حججاً صالحة، ولكن بمعرفة أن كل الاختيارات المنهجية تفعل ذلك فإن مشكلة التعصب لواحد من البدائل المنهجية الكثيرة لن تحل. طومسون صارم في منهجه، وإلتون أيضا. على أي أرضية أستطيع التفضيل؟ منهجية مارفيك؟ ولكن لماذا منهجيته؟ أليس محتملا أن يقول الذى يقوم بالاختيار في النهاية – لنقل – طومسون لأنه فقط يعجب بما يفعله طومسون بمنهجه؟ يحب دوافعه لكتابة التاريخ. ولأن جميع المنهجيات الأخرى متساوية فلماذا على المرء أن يختار؟
لنوجز: الحديث عن المنهج كطريق إلى الحقيقة مضلل؛ فهناك مجال واسع من المناهج بلا أي معايير متفق عليها للاختيار فيما بينها. عادة فإن من يفكرون مثل مارفيك يقولون بأنه برغم الاختلاف الكبير في المنهجيات بين، لنقل، الإمبريقيين والبنيويين فهم متفقون في الأساسيات. ولكن الأمر ثانية ليس كذلك؛ فالبنيويين يسهبون طويلا في توضيح أنهم ليسوا إمبريقيين؛ وأنهم قد اخترعوا منهجياتهم تحديدا لتمييز أنفسهم عن أي أحد آخر. إنها نقطة يبدو أن مارفيك وغيره تجاهلوها إلى حد ما.
أريد الآن أن أتعرض باختصار لمقولة إضافية تخص المنهج ونجدها غالبًا في المناقشات التمهيدية (في المقدمات) حول “طبيعة التاريخ”. هي مقولة تخص المفاهيم، وهي كما يلي: من الممكن أن تكون الفوارق بين المناهج محددة ونهائية؛ فهناك مفاهيم أساسية يستخدمها المؤرخون جميعًا، ألا يعني هذا وجود أرضية مشتركة ما بين المنهجيات المختلفة؟
الفكرة أنه وبالتأكيد، في جميع أنواع الكتابات التاريخية، يصادف المرء دائمًا ما يُدعى بـ “مفاهيم تاريخية” (وبعدم نعتها بأنها “مفاهيم مؤرخين” فهي تبدو غير شخصية، وموضوعية وكأنها تنتمى للتاريخ الذى يبدو بطريقة ما وكأنه قد كتب نفسه). ليس ذلك فقط؛ فهذه المفاهيم يُشار إليها عادة بأنها “أسس التاريخ” وهي مفاهيم مثل الوقت والأدلة التاريخية وضرورة إحساس المؤرخ بمادته التاريخية، والسبب والنتيجة والاستمرارية والتغير وهلم جرا.
أنا لن أناقشك الآن في ألا تعمل على تمحيص وتعديل المفاهيم. ولكنى قلق لأنه عند تقديم هذه المفاهيم تحديدًا يُعطى إيحاء بأنها واضحة بذاتها وأبدية وأنها تمثل أحجار بناء المعرفة التاريخية. لكن هذا أمر مثير للعجب، لأن من الأشياء التي يجب أن يؤديها فعل البحث في التاريخ هي العمل على “تأريخ” التاريخ نفسه، وأن نرى جميع المواقف التاريخية في سياقها المكانى والزمنى لا اعتبارها مفاهيم ثابتة وكونية، بل تعبيرات محددة ومحلية.. وهذا التأريخ سهل التوضيح في حالة المفاهيم العامة / المتفق عليها.
في مقال عن التطورات الجديدة في التأريخ، تأمل المتخصص في التعليم دونالد ستيل كيف أصبحت بعض المفاهيم المحددة “مفاهيم أساسية”، وأظهر أنه خلال عقد الستينيات كانت هناك خمسة مفاهيم أساسية كان يُنظر إليها بصفتها هي التي يتكون التاريخ منها: الزمن، المكان، التسلسل، الحكم الأخلاقي، الواقعية الاجتماعية. وأوضح ستيل أنه قد تم تعديل وضبط هذه المجموعة من المفاهيم (وقد شارك بنفسه في عملية ضبطها، ومعه آخرين) بحلول السبعينيات، لتقديم المفاهيم الأساسية للتأريخ، التي أصبحت: الزمن، الأدلة التاريخية، السبب والنتيجة، الاستمرارية والتغير، التشابهات والاختلافات. وقد شرح ستيل أن هذه المفاهيم قد أصبحت القواعد الرئيسية المعتمدة في تعليم التاريخ بالمدارس، وأنها كانت نافذة ومؤثرة في التعليم الجامعي الأولي، فضلًا عن تعاظم تأثيرها بشكل عام. من الواضح أن هذه المفاهيم الرئيسية القديمة التي قد تم العمل بها لأقل من عشرين عاماً ليست كونية، ولم تأت من منهجيات المؤرخين بقدر ما أتت من التفكير التعليمي العام. ومن الواضح أيضا تأثرها بالاتجاه الأيديولوجي، لأن ماذا كان ليحدث إذا استخدمت مفاهيم أخرى لتنظيم المجال، مفاهيم مثل: البنية-القدرة الفردية، الإفراط في تقدير الحتمية، تواشج المؤثرات، التنمية غير المتكافئة، المركز والهامش، المهيمن والهامشي، البنية الفوقية والسفلية، الجينيولوجيا، الهيمنة، النخب، البارادايم، إلخ؟ لقد حان الوقت للنظر إلى دور الأيديولوجيا – المباشر – في التأريخ.
دعني أبدأ بمثال، في هذه النقطة في الزمان والمكان، من الممكن أن تضع منهجًا معقولًا للتاريخ في أية مدرسة أو جامعة (على مستوى البكالوريوس) للتاريخ (يبدو كبقية مقررات التاريخ الأخرى) ولكن اختيار المادة الأساسية والمنهجية المتبعة يأخذ وجهة نظر السود الماركسيين النسويين، ولكنى أشك في وجود مقرر كهذا. لم لا؟. ليس لأنه في هذه الحالة لن يكون تاريخا، إنما لأنه تاريخ، ولكن لأن السود الماركسيين النسويين لا يملكون السلطة لوضع مثل هذا المقرر الذي سيتم تدريسه على نطاق واسع. ومع ذلك لو أن أحدا سأل أيا ممن قد يكون لديهم سلطة تحديد مكونات “المقررات المناسبة”، من لديه سلطة التأثير على المواد المتضمنة /المستبعدة؟ فالمرجح أنهم سيبررون عدم الظهور ذلك بأن مثل هذا المقرر (المتضمن لوجهة نظر السود الماركسيين النسويين) سيكون ذا اتجاه أيديولوجى وذلك لأن التاريخ في هذه الحالة سيأتي من اهتمامات خارجة عن التاريخ كما هو، وبالتالي سيصبح بمثابة وسيلة لتوصيل موقف محدد لأهداف إقناعية. هذا التمييز بين “التاريخ الأيديولوجى” و”التاريخ كما هو” مثير للاهتمام لأنه يفترض ضمنا – وهذا الافتراض مقصود – أن سرديات محددة للتاريخ (سردية السلطة الحاكمة عامة) ليست مؤدلجة على الإطلاق ولا تضع الناس في مواضع مسبقة ولا تقدم مشاهدات للماضي خارجة عن مادة التاريخ. ولكننا رأينا أن المعاني التي أعطيت للكتابات التاريخية من كل الأنواع هي بالضرورة ليست في صميم الماضي نفسه بل هي معاني ممنوحة للماضي من قبل أشخاص “خارجيين” عليه وخارجه. فالتاريخ ليس تاريخًا لنفسه أبدًا، إنما هو تاريخ في نظر شخص ما.
تبعا لذلك يبدو من المعقول القول بأن كل تكوين اجتماعي يريد من مؤرخيه أن يقدموا له أشياء معينة. ويبدو معقولا أيضا القول بأن المقولات التاريخية السائدة تصب في صالح الكتل الحاكمة الأقوى في التكوين الاجتماعي المعني، وليس الأمر أن تلك المقولات تتحقق تلقائيًا دون طعن عليها، وتكون آمنة ومستقرة في نظر الجميع وأنها “هي كذلك ببساطة”. في الحقيقة فإن تعبير “التاريخ كما هو” هو تعبير مؤدلج في حد ذاته، وهذا يعنى أنه يعاد صناعته وترتيبه بواسطة كل من يتأثر بطرق متنوعة بعلاقات السلطة؛ لأن كلا من المهيمن والخاضع للهيمنة لديه نسخته من حكايات الماضي التى تعطى شرعية لممارساتهم، وهي نسخ يجب أن يتم استبعادها بصفتها غير مناسبة، من أىة أجندة للخطاب السائد. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة ترتيب الرسائل التي سيتم بثها (ويقول الأكاديميون عادة عن إعادة الترتيب هذه أنها “مسائل خلافية” في التاريخ) هي عملية مستمرة نظرًا لاحتياجات المهيمنين/الخاضعين للهيمنة الدائمة بإعادة ترتيب العالم الحقيقي، مع سعي الطرفين إلى حشد وتعبئة الناس دعمًا لمصالحهم. التاريخ يُصاغ في قلب هذا الجدل، وبالطبع فإن هذه الاحتياجات المتضاربة للتاريخ تمس المناقشات (صراعات التملك) لتحديد ما هو التاريخ.
إذن، عند هذه النقطة، ألا نستطيع أن نرى أن الوسيلة لإجابة سؤال ” ما هو التاريخ؟” بطريقة واقعية، هو عن طريق استبدال “ما ” بـ “من”.. وزيادة حرف اللام لـ “من”.. فيصبح السؤال ليس “ما التاريخ؟” بل “لمن التاريخ؟”. إذا فعلنا ذلك ألن نرى أن كتابة التاريخ إشكالية فعلا لأنه يتكون من الألفاظ والحوارات المتنازع عليها والتي لها معان مختلفة لكل جماعة من الناس. تريد بعض الجماعات التاريخ منقى وقد غابت عنه أي نزاعات أو ضغوطات. البعض يريد أن يؤدى التاريخ إلى الطمأنينة. وبعضهم يريد للتاريخ أن يتضمن الفردية الواضحة. والبعض يريد أن يتضمن استراتيجيات وتكتيكات للثورة. والبعض يريد أن يعطى أرضيات للثورة المضادة، وهكذا. من السهل أيضًا أن نرى كيف أن التاريخ المكتوب للثوري مختلف عن الذى يريده المحافظ. ومن السهل أيضا أن نرى كيف أن قائمة استخدامات التاريخ بلا نهاية ليس فقط منطقيا بل أيضا عمليا. أعنى كيف سيبدو التاريخ إذا ما وافق ما يرضى عنه كل واحد للأبد. دعنى أعرض باختصار ما تعنيه هذه التعليقات باستخدام توضيح.
في روايته 1984، كتب أورويل أن هؤلاء الذين يتحكمون في الحاضر يتحكمون في الماضي، وأن من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل. يبدو هذا ممكنا خارج الأدب أيضا، لذلك فالناس يحتاجون إلى أسلاف ليعرفوا موقعهم ولكي يعطوا لتصرفاتهم الحالية والمستقبلية الشرعية اللازمة. (بالطبع في الحقيقة “حقائق” ما حدث في الماضي – وأي شئ آخر – لا تعطى الشرعية لأي شئ على الإطلاق بأخذ الحقيقة /القيمة في الحسبان، ولكن النقطة المطروحة هنا هي كيف يتصرف الناس وكأنهم يفعلون). إذن فالناس حرفيا يحتاجون لمد جذور لليوم والغد في أمسهم. في الوقت الحالي يتم البحث عن كل أمس (ويتم إيجاده، أخذا في الاعتبار أن الأمس يحتمل وسيظل يحتمل كل هذه السرديات) بواسطة النساء والسود والجماعات الإقليمية والأقليات المختلفة.. إلخ. تُصنع البرامج عن تفسيرات الماضي للوضع الحالي والمستقبل. في الماضي أيضًا سعت الطبقات العاملة لأن تُجذّر نفسها عبر مسارات ملفقة تاريخيا. وفي الماضي أيضًا، قبل ذلك، وجدت البرجوازية أصولها الماضية، وبدأت في بناء تاريخها لنفسها (وللغير). في هذا السياق تقوم كل طبقة/جماعة بكتابة سيرة ذاتية جمعية. فالتاريخ هو – جزئيًا – الطريقة التي يخلق بها الناس هوياتهم. فهو أكثر بكثير من مجرد صنف من المقررات الجامعية، وإن كان من المهم للغاية لجميع الأطراف المهتمة فهم كيف تُصاغ مقررات التاريخ التدريسية.
ألم نكن نعرف هذا طوال الوقت؟ أليس واضحاً تجذر ظاهرة مهمة و”مانحة للشرعية ” مثل التأريخ في الاحتياجات الحقيقية والسلطة؟ أعتقد أنه واضح؛ غير أنه عندما يشير الخطاب السائد إلى إعادة كتابة التواريخ الدائمة فإنه يفعل ذلك بطريقة تُزيح تلك الاحتياجات، فيلمٌح إلى أن كل جيل يكتب تاريخه الخاص. ولكن السؤال هو كيف ولماذا؟ والإجابة القابلة للجدل حولها – في إشارة إلى أورويل – هي لأن علاقات السلطة تخلق خطابا أيديولوجيا مثل “التاريخ كمعرفة” والذى يكون ضرورياً لجميع المنخرطين في ممارسات متعارضة للشرعنة.
دعونا نختتم مناقشة ما هو التاريخ نظريا. لقد حاججت بأن التاريخ مُكوّن من الإبستمولوجيا والمنهجية والأيديولوجية. تظهر الإبستمولوجيا (كيف نعرف) لنا أنه لا يمكن أبدا أن نعرف حقا ما حدث في الماضي، ذلك لأن الفجوة بين الماضي والتاريخ (التأريخ) هي فجوة أونطولوجية، أي أنها تكمن في جوهر الأشياء، بحيث أنه لا يكفي أي قدر من الجهد الإبستمولوجي (السعي المعرفي) لعبور تلك الفجوة. ابتكر المؤرخون طرقا للعمل لقطع الطريق أمام تأثير المؤرخين الذين يقدمون تأويلات وتفسيرات، باستخدام مناهج للتدقيق الصارم والتي حاولوا بطرق متعددة جعلها عالمية وصالحة لكل المواقف، بحيث إذا استخدمها الجميع صارت هناك مجموعة من مبادئ ومهارات وممارسات روتينية أساسية تؤدى إلى الموضوعية. ولكن هناك العديد من المنهجيات؛ والمفاهيم الأساسية السائدة عن التاريخ هي ذات بناء جزئي وحديثة التكوين. وقلت بأن الخلافات التي نراها لها سبب: أن التاريخ خطاب متنازع حوله، هو أرض معركة يشيد فيها الناس والطبقات والجماعات تأريخًا وتأويلًا للماضي يرضيهم دون غيرهم. لا يوجد تاريخ حاسم خارج هذه الضغوطات، وأي إجماع (مؤقت) لا يتحقق إلا عندما تتمكن الأصوات المهيمنة من إسكات الأصوات الأخرى بالاستعانة بالسلطة أو عندما تتمكن من استيعاب تلك الأصوات الأخرى. في النهاية التاريخ هو نظرية، والنظرية أيديولوجية، والأيديولوجية ليست أكثر من مصالح مادية. والأيديولوجية تتسرب إلى كل زاوية وشق في التأريخ، بما في ذلك الممارسات اليومية لصناعة التاريخ في المؤسسات المهيمنة داخل تكويناتنا الاجتماعية، وبخاصة الجامعات.
في الختام… نحو تعريف “التاريخ”
لقد سقت مقولة أن التاريخ بصورة رئيسية هو ما يكتبه المؤرخون، إذن لم النزاع، أليست تلك هي الحقيقة؟ بطريقة ما بلى، لكن من الواضح أنه ليس تمامًا. يسهل نوعًا ما وصف ما يفعله المؤرخون بالمعنى العملي الضيق حتى أنه يمكننا أن نكتب توصيفًا وظيفيًا عنه. لكن المشكلة تأتي عندما يتقاطع هذا النشاط، مثلما يجب عليه، مع علاقات السلطة ضمن أي تشكيل اجتماعي يصدر عنه. عندما تتساءل شعوب وجماعات وطبقات: “ما الذي يعنيه التاريخ لي / لنا وكيف يمكن استخدامه أو انتهاكه؟” يصبح التاريخ من هنا إشكاليًا للغاية في استخداماته ومعانيه، وعندما يتحول السؤال كما أوضحت من “ما التاريخ؟” إلى “لمن هذا التاريخ؟”. وأضع خلاصتي في هذا التعريف فيما يعنيه التاريخ لي:
التاريخ هو خطاب إشكالي متغير يبدو ظاهريًا أنه عن جانب من العالم، وهو الماضي، الذي ينتجه مجموعة من العاملين حاضري الذهن (وهم في ثقافتنا المؤرخون ذوي الرواتب الشهرية غالبًا) الذين يمضون في عملهم بطرق ذات سياق إبستمولوجي وأيديولوجي وعملي قابلة للتمييز بصورة متبادلة، فتصبح أعمالهم عند تداولها خاضعة لسلسلة من الاستخدامات والانتهاكات بلا نهاية منطقيًا، لكن تتوافق في العموم مع نطاق من أسس السلطة التي توجد في أي لحظة معطاة، فتهيكل معاني التواريخ وتفرقها حسب طيف المهيمن – المهمش.



